Subtotal: $
Checkout
لُمى بوما – هكذا يدعونني الأطفال الأمريكيون. لُمى بوما مونتيزوما. [تعني كلمة بوما Puma قِطًّا مُفترسًا كبير الحجم، وكلمة مونتيزوما Montezuma اسم إمبراطور.] لقد جعلتني سخريتهم مني أتمنى أن لا أكون قد جئتُ إلى أمريكا على الإطلاق. وجعلتني أكره اسمي والمكان الذي جئت منه. وجعلتني أيضًا أكره كل شيء يَخُصُّني.
لقد وُلدتُ في بغداد لأم كلدانية كاثوليكية وأب سرياني أرثوذكسي، ولكن أسلافي هم من مواليد الموصل وما يجاورها من المدن شمالي العراق. ولسنين عديدة في أمريكا، ومهما كان المكان الذي عشتُ فيه، أجبتُ على السؤال: «من أين أنتِ؟» بـ «إني من الموصل.» وكانت هذه هي الحقيقة الوجودية لمهاجرين من الجيل الأول — تكامل وتوتر معًا داخل النفس بين حضارتين — والرغبة الحزينة في هوية واحدة، وثقافة واحدة، ووطن واحد، ونظرة متكاملة واحدة نحو العالم.
كانت سنواتي الأولى في العراق مليئة بذكريات حيوية: فأتذكر أني كنتُ أغمس الخبز في الشاي والحليب الذي اعتادت جدتي أن تُحضِّره لي، وكان عمي يأخذني إلى بائع الزلابية، وهي عبارة عن عجين مقلي منقوع بالقطر. وأتذكر أيضًا الرقص الشرقي وما يصحبه من تصفيق وصياح الاستحسان من قِبل أجدادي. وكان والدي مُعلِّمًا يُعلِّم علم الحشرات، وعلم النبات، وتربية النحل، وكانت والدتي مُعلِّمة في مدرسة ثانوية.
غير أن حياتنا في العراق لم تكُن مثالية. فقد جرى التلاعب بأبي مثل بيدق وكبش فداء بين الشيعة والسُّنَّة في العمل، وأُجبِرت أمي على لبس ثياب المسلمين في السوق. وأحيانًا كنتُ أعود من المدرسة باكية، لأن المُعلِّم قد ضرب راحتي بالمسطرة، فقد كان المُعلِّمون المسلمون قساة دائمًا على الطلاب المسيحيين — على الأقل هذا ما كان يبدو لنا نحن في المجتمع المسيحي. ولن أنسى أبدًا يوم جاءت أمي إلى البيت غاضبة، لأني قد وُضِعتُ في المرتبة الثانية في صفي، بينما قد أُعطِيت المرتبة الأولى لفتاة مسلمة كانت قد سجلت درجة واحدة أعلى مني في مادةٍ واحدةٍ فقط هي التربية البدنية. ولم يَدُمْ الأمر طويلاً بعد تلك الحادثة حتى بدأتُ أسمع والديَّ يتحدثان عن أننا لم يَعُد لدينا «مستقبل في هذا البلد.» وما أن حَلَّ الوقت الذي بدأتُ فيه القدوم من المدرسة إلى المنزل وأنا أغني أغاني حزب البعث الدعائية، حتى كانا قد حزما أمرهما.
باع أبي سيارته الفيات، وحزمنا نحن حقائبنا، وقلنا إننا ذاهبون في عطلة إلى اليونان. وما أن وصلنا إلى أثينا حتى باشر أبي بالعملية الطويلة لطلب اللجوء. وبعد أن تقدَّم بطلب اللجوء الدائم للعديد من الدول ورُفِض طلبه، سمعنا أن عائلة أرمنية في لوس أنجلس قد عرضت كفالة مالية لنا لتسهيل الهجرة. ولم أكُن راغبة في التنقل ثانية، بل أردتُ أن أبقى في اليونان أو العودة إلى العراق، فقد اشتقتُ إلى أجدادي. وحاولتْ أمي أن تفرحني، واعِدةً بأنها ستشتري لي الموز والبرتقال عندما نصل إلى بيتنا الجديد.
هبطت طائرتنا في لوس أنجلوس بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1978م. وكانت صدمةُ الهجرة من حضارة مشرقية، وتطلُّع إلى الغرب، كأنها تصادم داخل كياني بالذات. واستقرينا في مدينة فوليرتون Fullerton، في ولاية كاليفورنيا، حيث لم يكُن يوجد عراقيون أو عرب في ذلك الوقت، على الأقل لم نعرف أحدًا منهم. وكُنَّا في عطلة نهاية كل أسبوع نقوم برحلة الثلاثين ميلاً لكي نزور العراقيين الآخرين الوحيدين الذين كُنَّا نعرفهم، وهي العائلة الأرمنية التي كفلتنا. أمَّا في الوقت الذي لم نكُن نزور فيه تلك العائلة الأرمنية، فقد كان من الصعب عليَّ التواصل مع زملائي في الصف، ومع المدرسين، ومع أفراد آخرين في مجتمعنا. فقد كنتُ أعرف أربع كلمات إنجليزية: نعم، ولا، ورجاءً، وشكرًا.
ذهبنا في خلال الشهر الأول من وصولنا إلى أمريكا إلى كنيسة إنجيلية في مدينة فوليرتون Fullerton. وهناك، تركني والديَّ في مدرسة الأحد. وقيل لهم إنَّ هذا ما يُفترض القيام به. وعندما حلَّ وقت الوجبة الخفيفة، أُعطيتُ موزة وقطعتين من الخبز الأسمر بحشوة بنية اللون داخلها. ولم أكُن قد ذقتُ زبدة الفول السوداني من قبل أبدًا، لكنني كنتُ أتضوَّر جوعًا. فأخذتُ قضمة من الشطيرة، فامتلأ فمي من المادة الجافة واللزجة. وشعرتُ بشفتيَّ وكأنهما قد التصقتا معًا. فأردتُ أن أبكي، ولكنني كنتُ خائفة من الأطفال الآخرين أن يضحكوا عليَّ. لذلك كتمتُ بكائي، وذهبتُ إلى مقدمة الصفِّ، وأمسكتُ شطيرة زبدة الفول السوداني بإحدى يديَّ، وبالأخرى الموزة. وكنتُ أحاول أن أسأل المعلمة أن تسمح لي بعدم أكل الشطيرة. فأومأتُ لها بيديَّ الاثنتين محاولة أن أسأل فيما إذا كان من الممكن لي أن آكل الموزة بدون الشطيرة. فظَنَّتْ المُعلِّمة أني أردتُ أن آكل الشطيرة دون الموزة، لذلك أخذتْ الموزة وتركتْ لي شطيرة زبدة الفول السوداني. فذهبتُ وجلستُ والدموع تنهمر على وجهي.
لم يغادرني الاضطراب النفسي التي عانيتُ منه خلال تلك السنوات مطلقًا. وقد شكَّل شخصيتي، وعلَّمني كيف أرى الهوية الإنسانية والهجرة.
بعد وقت قصير من وصولنا إلى كاليفورنيا، حصل والداي على وظائف في كاليفورنيا. وبسبب عدم وجود أقارب لنا أو أصدقاء لأسرتنا قريبين مِنَّا لكي يهتمون بنا خلال غياب والداي في عملهما، أصبحنا أنا وأختي من أطفال المفاتيح الذين يعودون من مدارسهم إلى منزل فارغ بسبب عمل الوالدين. وكانت المكتبة العامة للمدينة هي مربيتنا خلال العطل الصيفية. وواجهتُ صعوبة في فهم المُعلِّم وزملائي، عندما كنتُ في الصف الرابع في مدرسة ريموند الابتدائية. غير أن مشهدًا واحدًا لا يزال عالِقًا في ذاكرتي — فقد رأيتُ المُعلَّم جالسًا على كرسي في مقدمة الصف ويقرأ من كتاب. وللحظاتٍ قليلةٍ، توقف الزمن واستراحت روحي من اضطرابها. فرغم أني لم أفهم كلمة مما كان يُقرأ، إلاَّ أن صورة الغلاف لذاك الكتاب انطبعت في ذهني؛ إذ كانت صورة رواية «شبكة تشارلوت» الشهيرة. وبمجرد تمكُّني من قراءة الإنجليزية بنفسي، هممتُ بقراءة هذه الرواية بسرعة وكأنني التهمها.

أسد بابل، رمز الثقافة العراقية المعترف به على نطاق واسع، ومرسوم على بوابة عشتار، التي بناها نبوخذ نصر في سنة 575 قبل الميلاد. Images from www.ancient.eu/Ishtar_Gate and Wikimedia Commons.
عندما حصلت أزمة الرهائن في إيران، ندب أبي حظَّه، وقال إنَّ مشاكل الشرق الأوسط قد تبعتنا إلى أمريكا. وحذَّرنا والدانا من أن نقول إننا من العراق، خشية أن يظن الناس أننا كُنَّا نؤيد ما يحصل، الأمر الذي لم نكُن نؤيده بطبيعة الحال. وأخبرانا هذا: «قولا فقط: ‹إننا من اليونان› إذا سألكما أحد.» وعندما اندلعت الحرب الإيرانية–العراقية في عام 1980م التي دامت ثماني سنوات، شعر والدايَ بالارتياح لأننا كُنَّا نعيش في أمريكا. فقد نجا والدي من التجنيد في الجيش. غير أن فرد آخر من الأسرة الذي كان يسكن في العراق قد أُرسِل إلى الخطوط الأمامية. وكانت المحادثات الهاتفية مع أقاربنا في العراق حول مستجدات الأمور قصيرة ومُصاغة بعناية — إذ لم تكنْ تَعلم مطلقًا مَنْ كان يتصنَّت على المكالمات الهاتفية، وكان الجميع في العراق يعيشون في خوف من حكومة صدام حسين. فقد سمعنا تقارير عن أن أطفال المدارس قد تم خداعهم للإبلاغ عن آبائهم، وأي شخص يتحدث علنًا ضد صدام يمكن أن يُسجن أو يُقتل.
وفي عام 1990م، غزا صدام الكويت. ثم جاء بعده يوم 16 كانون الثاني/يناير من عام 1991م، وهو اليوم الذي بدأت فيه أمريكا، وهي البلد الذي تجنَّستُ فيه، باجتياح العراق، بلد مسقط رأسي وتراثي. لقد كانت اللحظة الأكثر تنافرًا في حياتي. فبكيتُ. وصلَّيتُ من أجل أن ينجو أفراد عائلتي الأعزاء. وشعرتُ بأن هويتي المزدوجة هي محطُّ الاختبار. وهنا أصبحت عائلتي تخشى مرة أخرى في أمريكا من أن يديننا الآخرون إذا عرفوا أننا عراقيون. فحاولنا تجنُّب ذكر المكان الذي أتينا منه عندما كُنَّا مع أمريكيين آخرين. ومع ذلك، لم نكُن نسلم من الخلافات حتى بين الناس ذوي الأصل العراقي. ففي كل مرة كُنَّا نجتمع فيها مع أصدقاء عراقيين آخرين، فإذا بالجدالات تندلع: «إنه ذنب صدام، فهو يستحق ذلك!» «لا، الأميركيون هم الذين جعلوه حجر شطرنج لهم في المنطقة، والآن انقلبوا عليه.» وهكذا كانت الجدالات تستمر دون انقطاع، لكنه كان مجرد كلام — فلم يكُن أحد مِنَّا قادرًا على فعل أيِّ شيء حيال ذلك.
وكان هناك وقتٌ عندما كان فيه العراق بلدًا صاعدًا. إذ كان يملك شوارع معبَّدة جيدًا، وأبنية حديثة، وسباكة ناجحة، وغيرها من البُنى التحتية ومؤسسات أخرى. فإذا نظر الأمريكي إلى الأفلام العربية من ستينيات القرن الماضي كان سيرى بشكلٍ ملحوظٍ مجتمعًا حديثًا. إذ ازدهرت الحياة العائلية، وأصبحت النساء فيه مُتعلِّمات، ونمت التقاليد والثقافة القائمة على الأسرة، على الرغم من أن الفلسفات الجديدة من الغرب كانت تأتي تباعًا من خلال أولئك الذين درسوا في الخارج. وربما أن العلاقة بين المسيحيين والمسلمين لم تكُن مثالية، إلاَّ أنه لم تكُن هناك إراقة دماء. أمَّا الآن، فقد تخلَّف العراق عقودًا، وقد يقول البعض قرونًا. فالمباني مُهترئة ومُتقشِّرة ومُهدَّمة. وهناك حالة من عدم اليقين والشكوك حول إعادة بناء المنظومات القديمة، سواء كانت المادية منها أو الاجتماعية.
أما ما يؤلِم قلبي أكثر من الضرر المادي، فهو تفكك الحياة الأسرية. ففي الوقت الذي لم تكُن توجد فيه دار رعاية واحدة للمسنّين في كل أنحاء بغداد (لأن العائلات كانت تتكفل دائمًا برعاية مُسنِّيها)، توجد الآن دارين للرعاية على الأقل، وهذا يعود جزئيًّا إلى أن العديد من الشبَّان العراقيين قد هربوا من العراق. وهذه ليست مجرد مسألة تحوُّل سكاني (ديموغرافي)؛ بل هي أيضا من أحد أعراض التغيير في العقلية الذي يبيح الآن لجيل الشباب أن يهجر مُسِنِّيه.
إنَّ أرض أجدادي، الأرض التي وُلدتُ فيها، الأرض التي عشتُ فيها السنين السبعة الأولى من حياتي، قد دُمِّرتْ بالكامل بموجةٍ بعد موجة من العنف. فشعب العراق قد تعب، وانهارت روحه المعنوية، ويكابد ضائقة ثقافية واقتصادية. وحتى لو تمكَّنا من طرد داعش من العراق، فعلينا أن نحثَّ حكومتنا على التفكير فيما هو أبعد من النتيجة العسكرية. ولَمَّا كانت لأمريكا يد في صنع هذا التحوُّل في الأحداث، فإنها تتحمل مسؤولية كبيرة في العمل على شفاء البلد وإعادة إعماره.
كان سلفي إبراهيم يعيش في أور، فيما بين النهرين، عندما دعاه الله أن يخرج من أرض آبائه ليكون مهاجرًا ونزيلاً إلى اليوم الذي يعطيه فيه الله، ولنسله من بعده، أرض كنعان (اليوم أرض إسرائيل). وتوصف حياة المسيحي في العهد الجديد بأنها هجرةٌ وحجٌ إلى ديار جديدة، إلى بيتنا السماوي. وأنا لا أعرف كيف فعلها إبراهيم، أمَّا بالنسبة إليَّ فأنا كنتُ دائمًا أشعر شعورًا قويًّا بعدم انتمائي لا إلى العراق ولا إلى أمريكا.
وربما يعود السبب إلى أني لم أتفاجأ في السنوات الأخيرة برؤية صعود الحركات القومية في الغرب. ورغم أن التفاصيل قد تختلف من حركة لأخرى، إلاَّ أنها كلها حركات متنوعة حول الموضوع نفسه: أزمة حضارية جذورها في أزمة الهوية. فقد نبذ الغرب إلى حدٍّ كبير تراثه الثقافي والروحي، الذي كان مُتجذِّرًا في قيم الكتاب المقدس. ولنَقرُن هذه الظاهرة بتدفق اللاجئين — وخاصة من الشرق الأوسط — الذين، لسبب أو لآخر، لا يتقبَّلون الفكر الغربي السياسي والفلسفي والثقافي. ولسنا بحاجة إلى أن نكون فلاسفة سياسيين لكي نفهم ما نراه، عندما نشاهد حضارة تتصارع مع أخرى. إذ إننا نشعر بهذا الصراع في كل مكان حولنا.
وبدأ الكثير مِنَّا بالتساؤل: «مَنْ أنا وما هي أُمَّتنا؟» وتقود هذه الأسئلة عن الهوية إلى أسئلة عن القومية. ولا أحد يشعر بعمق هذا التنافر أكثر مما يشعر به المهاجرون. فالمهاجر، وخاصة الذي عبر الحدود الحضارية بالإضافة إلى الحدود الوطنية، سيعاني في أغلب الأحيان من أزمة هوية. ولهذا السبب، فإنَّ فهم عقلية المهاجرين أمر بالغ الأهمية لفهم الأزمة التي يمر بها الكثيرون في العالم.
إنَّ أبرز حقيقة التي يتعيَّن على الأميركيين والحكومة الأميركية أن يدركوها فيما يخُصُّ العراق (أو أيَّ دولة غير غربية) هي أن هناك نموذجًا ورؤية عالمية غير غربيين، وأنهما صالحان وصحيحان. فهناك طريقة أخرى للحياة، ولبناء الاقتصاد، وللحكم، غير التي نعرفها في الغرب. وبالتأكيد أنا لا أعادل بين الطرق المعبدة والسباكة وبين الإمبريالية الثقافية؛ وإنما أنا أشير إلى العلاقات، والمفاوضات السياسية، وكيفية تقييم الناس لإحساسهم بالرفاهية. ويمكنك أن تناقش مزايا العراق كيفما تشاء، ولكن عليك أن تحترم الشعب، وأرضه، وثقافته، وطريقته في الحياة. فلن يصبح العراق أمريكا أبدًا، وعلينا أن نكُفَّ عن محاولة تصوير الشعوب والبلدان على صورتنا. فنحن لسنا خالقيهم. وإذا أردنا أن نلعب دورًا في إعادة بناء الدولة، فعلينا أن نفعل ذلك على حسب مصالحهم وليس مصالحنا. ثم إنَّ تحقيق الحرية لشعب ما يبدأ باحترامه كشعب له حقُّه الخاص به في تقرير مصيره. وقد يبدو هذا أمرًا صغيرًا، ولكن من الواجب علينا أن نفهمه. ومن أسلوب التفكير هذا سوف تتدفق استراتيجية مختلفة لإعادة البناء والشفاء.
في هذه الأيام، عندما يعرف الناس أني مسيحية عراقية، فعادة ما يسألونني عن شعوري أو عن رأيي فيما يحدث في الشرق الأوسط. ويجب أن أقول إنَّ مشاعري وأفكاري معقدة. ففي حالة داعش في العراق، فإنَّ الثقافة المسيحية التي يجري تدميرها هي تراثي، والناس الذين يُقتلون هم أقاربي. وقد سمعتُ الناس يخبرونني بأن أحب عدوي، ولكن ماذا يعني أن تحب عدوك عندما يصوب العدو مسدسًا إلى رأسك أو يضع سيفًا على رقبتك؟ فإنَّ تفكير المهاجر معقد، وفي هذا العصر الذي يشهد أزمة لاجئين كبرى وحركات نزوح كبيرة للناس، يصبح العمل من أجل فهم مشترك أمرًا بالغ الأهمية.
وعادة ما كانت أمي تقول: «إذا أنكرت أصلك، فإنك تنكر نفسك.» وقد عشتُ فترة كافية لأعلم أن هذا صحيح. أمَّا أنا فأشعر بالارتياح عندما أعرف أنني دائمًا جزء من ملكوت الله، أينما كنتُ في العالم. ويكتب النبي إرميا في العهد القديم من الكتاب المقدس رسالة إلى المنفيين في بابل يقول فيها:
«هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ لِكُلِّ السَّبْيِ الَّذِي سَبَيْتُهُ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى بَابِلَ: اِبْنُوا بُيُوتًا وَاسْكُنُوا، وَاغْرِسُوا جَنَّاتٍ وَكُلُوا ثَمَرَهَا. خُذُوا نِسَاءً وَلِدُوا بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَخُذُوا لِبَنِيكُمْ نِسَاءً وَأَعْطُوا بَنَاتِكُمْ لِرِجَالٍ فَيَلِدْنَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، وَاكْثُرُوا هُنَاكَ وَلاَ تَقِلُّوا. وَاطْلُبُوا سَلاَمَ الْمَدِينَةِ الَّتِي سَبَيْتُكُمْ إِلَيْهَا، وَصَلُّوا لأَجْلِهَا إِلَى الرَّبِّ، لأَنَّهُ بِسَلاَمِهَا يَكُونُ لَكُمْ سَلاَمٌ.» (إرميا 29: 4–7)
وبالرغم من أنني قد شعرتُ في أوقات مختلفة من حياتي بالاضطراب النفسي في داخلي، حيث كانت «أنا الأمريكية» في صراع مع «أنا العراقية»، إلاَّ أن إيماني المسيحي كان دائمًا يساعدني على فهم مكاني وهدفي في الحياة وأنا أعيش مهاجرة – وينعم عليَّ أيضًا بالتعزية الروحية إلى حدٍّ ما. ويقول الرب الإلَه على لسان النبي إشعياء:
«لاَ تَخَفْ فَإِنِّي مَعَكَ. مِنَ الْمَشْرِقِ آتِي بِنَسْلِكَ، وَمِنَ الْمَغْرِبِ أَجْمَعُكَ. أَقُولُ لِلشِّمَالِ: أَعْطِ، وَلِلْجَنُوبِ: لاَ تَمْنَعْ. اِيتِ بِبَنِيَّ مِنْ بَعِيدٍ، وَبِبَنَاتِي مِنْ أَقْصَى الأَرْضِ. بِكُلِّ مَنْ دُعِيَ بِاسْمِي وَلِمَجْدِي خَلَقْتُهُ وَجَبَلْتُهُ وَصَنَعْتُهُ.» (إشعياء 43: 5–7)
أنا ابنةٌ لله التي جاء بها من الشرق. أمَّا المكان الذي أعاد الله فيه خلقي لأصير الشخص الذي يريده هو، فقد كان في الغرب – تركيبة من الشرق والغرب – وجمعني في ملكوته، حيث يصبح كل شعبه واحدًا.
 جندي أمريكي يفتش رجلا مسنا عراقيا بحثا عن سلاح أثناء الغزو عام 1991. Photograph © Johnny Saunderson / Alamy Stock Photo
جندي أمريكي يفتش رجلا مسنا عراقيا بحثا عن سلاح أثناء الغزو عام 1991. Photograph © Johnny Saunderson / Alamy Stock Photo
لُمى سيمس زميلة مشاركة في موقع The Philos Project ومؤلفة كتاب Gospel Amnesia: Forgetting the Goodness of the News.
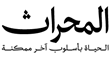




داوود
اسعد الرب اوقاتكم لو تعاقبت على العراق حكومات انسانيه منذ 1958 لما حصل الذي حصل في العراق لأنه الانسانيه لا تعني عرق او دين او نظام حكم في العراق لا يوجد شعب بل توجد كتل بشريه تجمعهم جامعه ويامنون بتقاليد دينية باليه يعتنقون اي فكرة فاسده العراق يحتاج إلى ثورة في باطن التقاليد تربى عليها أجيال جديده تأمن برسالة السلام والتآخي التي جاء بها الرب يسوع