Subtotal: $
Checkout
لا يَحسُنُ أنْ يكونَ آدمُ وحدَهُ
نعمة الزواج المقدسة
بقلم يوهان كريستوف آرنولد Johann Christoph Arnold
5 فبراير. 2018
وقالَ الرّبُّ الإلهُ: «لا يَحسُنُ أنْ يكونَ آدمُ وحدَهُ، فأَصنعُ لَه مَثيلاً يُعينُه.». . . . فأوقَعَ الرّبُّ الإلهُ آدمَ في نَومِ عميقٍ، وفيما هوَ نائِمٌ أخذَ إحدى أضلاعِهِ وسَدَ مكانَها بِلَحْمِ. وبنى الرّبُّ الإلهُ اَمْرأةً مِنَ الضِّلعِ التي أخذَها مِنْ آدمَ، فجاءَ بِها إلى آدمَ. فقالَ آدمُ: «هذِهِ الآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظامي ولَحمٌ مِنْ لَحمي هذِهِ تُسَمَّى اَمرأةً فهيَ مِنْ اَمرِئٍ أُخذَت.» تكوين 2: 18 وَ 21 – 23
لا يوجد أصعب من تحمُّل الوحدة. لقد قيل أن المساجين المسجونين في حبس انفرادي يفرحون عند مشاهدتهم للعنكبوت – فقد رأوا على الأقل شيئا ينتمي إلى عالم الأحياء. لقد خلقنا الله لنكون كائنات اجتماعية. في حين نرى عالمنا المعاصر مجردا من العلاقات تجريدا فظيعا. فقد عمل التقدم التكنولوجي على تدهور الأواصر والعلاقات الاجتماعية في المجتمع. وجعل الناس يبدون غير ضروريين شيئا فشيئا. وبينما أصبح كبار السن يوضعون في أماكن منعزلة أو بيوت للعناية الشخصية، وبينما اُستُبدِل عمال المصانع بالإنسان الآلي، وبينما صار الشباب من الجنسين يبحثون عاما بعد عام عن عمل هادف وله معنى، فإذا بالناس يقعون ضحية اليأس وخيبة الأمل من جراء كل ذلك. وأخذ بعضهم يعتمد على مساعدة أخصائيّ العلاج الطبيعي أو الأطباء النفسانيين، في حين أخذ آخرون يبحثون عن سبيل للهروب من الواقع المرير كالإدمان على الكحول أو المخدرات أو الانتحار. وبسبب القطيعة مع الله ومع الآخرين، يعيش الآلاف من الناس في يأس وابتئاس صامتين.
إن العيش بعزلة عن الآخرين يؤدي إلى اليأس، سواء كانت عزلة داخلية أو خارجية. ويكتب الراهب الأمريكي توماس ميرتون Thomas Merton (وهو من أشهر الكتّاب الكاثوليك في القرن العشرين) فيقول:
إن اليأس هو الحالة التي يصل إليها الإنسان بسبب تطرّفه المطلق في حبّ الذات. ويحدث هذا عندما يدير المرء ظهره عمدا لكل المساعدات التي تُقدم إليه رغبة منه في تذوّق قِمة عفونة الضياع. . . .
فاليأس هو ذروة استفحال الكبرياء بدرجة بالغة ومغرورة بحيث إن المرء يُفَضِّل التعاسة المطلقة لعذاب جهنم على قبول السعادة من يدي الله والإقرار بأن الله هو فوق الجميع وبأنه ليس بمقدورنا تقرير مصيرنا بأنفسنا (بل بِعَونِه فقط).
غير أن الإنسان المتواضع بحقّ لا ييأس، لأنه لم يعد فيه أي إشفاق على الذات.
نرى هنا أن الكبرياء لعنة تؤدي إلى الموت. أما التواضع فيؤدي إلى المحبة. والمحبة أعظم نعمة موهوبة لبني البشر؛ إنها دعوتنا الإلهية الحقيقية. إنها بمثابة قول «نعم» للحياة، و «نعم» للحياة المشتركة. ثم إن المحبة وحدها هي الكفيلة بتحقيق اشتياق إنساننا الداخلي.
خلقنا الله لنعيش مع الآخرين ومن أجل الآخرين
لقد غرس الله في كل منّا اشتياقا غريزيا إلى تحقيق شَبَهٍ مقارب له، فقد غرس فينا اشتياقا يحثنا على السعي إلى المحبة وإلى الحياة المشتركة وإلى الوحدة. ويشير يسوع المسيح في صلاته الأخيرة إلى أهمية هذا الاشتياق:
فَلْيكونوا بِأَجمَعِهم واحِداً: كَما أَنَّكَ فِيَّ، يا أَبَتِ، وأَنا فيك فَلْيكونوا هُم أَيضاً فينا لِيُؤمِنَ العالَمُ بِأَنَّكَ أَنتَ أَرسَلتَني. (يوحنا 17: 21)
لا يمكن لأي إنسان أن يحيا حياة حقيقية من دون أن يمتلئ صدره بالمحبة نحو الآخرين: فإرادة الله لكل إنسان هي أن يلعب دور الله «المُحِب» نحو الآخرين. فكل شخص مدعو ليحب وليساعد الذين من حوله نيابة عن الله (راجع تكوين 4: 8–10).
يريد الله منا إقامة علاقات أخوية حميمة بعضنا مع بعض، ومساعدة بعضنا لبعض بدافع المحبة. ولا يوجد طبعا أي شك في أننا لو أحسسنا بما ينبض في قلوب إخواننا أو أخواتنا في مجتمع كنيستنا لأمكننا عندئذ مساعدتهم، لأن «المساعدة» التي نقدمها موهوبة من قبل الله نفسه. كما يقول القديس يوحنا الرسول:
نَحنُ نَعرِفُ أنَّنا انتَقَلنا مِنَ الموتِ إلى الحياةِ لأنَّنا نُحِبُّ إخوَتَنا. مَنْ لا يُحِبُّ بَقِيَ في الموتِ. (1 يوحنا 3: 14)
فحياتنا لا تكتمل إلا عندما تتوهج فيها المحبة وإلا عندما تبرهن المحبة ذاتها بالأعمال وتثمر ثمارا ملموسة.
ويخبرنا يسوع بأن أعظم وصيتين هما أن نحب الله بكل قلبنا ونفسنا وقوتنا، وأن نحب القريب مثل نفسنا (معنى القريب أخونا الإنسان). ولا يجوز فصل هاتين الوصيتين إحداهما عن الأخرى: فلابد لمحبتنا لله أن تعني دائما محبتنا للقريب. فلا يمكننا إقامة علاقة مع الله إن كنا نتجاهل الآخرين، كما يوصينا الإنجيل:
فعلَينا أن نُحِبَّ لأنَّ اللهَ أحَبَّنا أوَّلاً. إذا قالَ أحدٌ: «أنا أُحِبُّ اللهَ» وهوَ يكرَهُ أخاهُ كانَ كاذِبًا لأنَّ الّذي لا يُحِبُّ أخاهُ وهوَ يَراهُ، لا يَقدِرُ أنْ يُحِبَّ اللهَ وهوَ لا يَراهُ. وَصِيَّةُ المَسيحِ لنا هِيَ: مَنْ أحَبَّ اللهَ أحَبَّ أخاهُ أيضًا. (1 يوحنا 4: 19–21)
فطريقنا إلى الله عليه أن يكون عن طريق محبة إخوتنا وأخواتنا البشر، أما في الزواج فيكون عن طريق محبة شريك الحياة.
لو امتلأنا من محبة الله فلن نكون أبدا وحيدين أو منطويين على نفسنا لمدة طويلة، لأننا سوف نجد دائما شخصا نقدم له أعمال المحبة والخدمة. وسيكون الله وأخونا الإنسان موجودين قريبين منا دائما. وكل ما علينا القيام به هو البحث عنهما. لقد جاءني مؤخرا أحد الشباب من مجتمع كنيستنا واسمه شان Sean ليشاركني بفرحته التي اكتشفها حديثا وهي مساعدة الآخرين. فقد كان شان يعيش في مدينة بولتيمور الأمريكية ويعمل كمتطوع لبناء المنازل للمحرومين الذين يفتقرون إلى المأوى. وكان يظن أن عمله هذا يكفي لشفاء غليله، ولكنه عندما كان يعود إلى بيته في نهاية النهار، لم يكن يعرف ماذا يفعل، فيقول:
رأيتُ روحي تضعف وتفرغ عند قضاء وقتي أمام شاشة التلفزيون. وسرعان ما أخذتْ بهجة الحياة التي في داخلي تتلاشى. وقد أخبرني أحد الأشخاص وقتذاك عن وجود برنامج مسائي للمساعدة في تدريس الأطفال المشردين في المدينة، فقد كانوا يفتشون تفتيشا يائسا عن متطوعين. لذلك أردتُ تجريب هذا العمل. وها أنا الآن أقدم المساعدة في هذا المجال في كل مساء. ولا أصدق كيف تغيرت نظرتي للحياة كليّا. فلم أكن أعلم سابقا على الإطلاق كم كان يترتب عليّ تقديم أعمال المحبة والخدمة إلى هؤلاء الأطفال.
عندما نعاني من الشعور بالوحشة أو العزلة، فالسبب يرجع على الأغلب إلى أننا شخصيا لا نريد أن نحب الآخرين بل نريد أن يحبنا الآخرون. غير أن السعادة الحقيقية تأتي من خلال إبداء المحبة للآخرين. فالشيء الذي يلزَمُنا هو أن نسعى إلى إقامة علاقات أخوية مع أخينا الإنسان باستمرار، وينبغي أن يصير كل منّا مُعينا كأخ أو كأخت في سعينا هذا. فلنسأل الله لكي يفتح قلوبنا المغلقة على هذه المحبة، عالمين أننا لا نقدر على الحصول عليها إلا بالتحلّي بتواضع الصليب.
باستطاعة أي إنسان أن يصبح أداة لمحبة الله
في قصة خلق آدم وحواء، يتضح بجلاء أن الرجل والمرأة قد خُلقا لكي يعين ويسند ويكمل أحدهما الآخر. أما فرحة الله فكانت بالتأكيد كبيرة وهو يُحضِر المرأة إلى الرجل، والرجل إلى المرأة. ولكوننا جميعا مخلوقين على صورة الله وشبهه، فينبغي نحن أيضا أن نلاقي الآخرين بالفرح والمحبة سواء كنا متزوجين أو عزاب.
فبإحضار حواء إلى آدم أظهر الله لجميع البشر دعوتهم الحقيقية؛ وهي أن يكونوا مساعدين يكشفون محبة الله للعالم. وبتقديم ابنه الحبيب يسوع لنا، فإن الله الآب يبيّن لنا أنه لن يتركنا وحيدين أو بدون عون. فقد قال يسوع بنفسه:
لن أترُكَكُم يتامى، بل أرجِعُ إلَيكُم. (يوحنا 14: 18)
ثم إن السيد المسيح يوعدنا قائلا:
أنّ مَنْ قَبِلَ وصاياي وعَمِلَ بِها أحَبَّني. ومَنْ أحَبَّني أحَبَّهُ أبي، وأنا أُحِبُّهُ وأُظهِرُ لَه ذاتي. (يوحنا 14: 21)
فمن يقدر على أن يفهم سمو هذا الكلام والأمل الذي فيه لعالمنا المضطرب؟ وعسى أن يتأكد كل من هو وحيد ومن فقد عزيمته ومن خاب أمله بأن الله لن يتخلى عنه أبدا. ولن يكون وحيدا أبدا حتى لو لم يتمكن من إيجاد أية صداقة بشرية. فلو لم يتخلَ الإنسان عن الله، لما تخلى الله عنه أبدا.
لقد جمع الله آدم وحواء ليشفيهما من العزلة وليحررهما من الانفرادية، وهذا ما يريده الله كذلك لكل رجل وامرأة يجمعهما في الزواج. غير أن الزواج في حد ذاته لا يقدر على أن يصنع الشفاء من العزلة والتحرر من الانفرادية. فما لم نثبت في المسيح لن نأتي بأي ثمر صالح. فعندما نحب المسيح، الذي هو وحده سندنا ورجاؤنا وحياتنا، فسوف نطمئن بأن أحدنا سوف يتعرّف على الشريك الآخر ويحبه. أما لو عزلنا أنفسنا عن المسيح فلن يسير أي شيء سيرة حسنة. فهو الوحيد الذي يوحِّد ويجمِّع كل شيء، وهو الذي يفتح لنا الأبواب على مصراعيها لنلتقي مع الله ومع الآخرين، مثلما يشهد عنه الإنجيل:
كانَ قَبلَ كُلِّ شيءٍ وفيهِ يَتكوَّنُ كُلُّ شيءٍ. هوَ رأسُ الجَسَدِ، أي رأْسُ الكَنيسَةِ، وهوَ البَدءُ وبِكرُ مَنْ قامَ مِنْ بَينِ الأمواتِ لِتكونَ لَه الأوَّلِيَّةُ في كُلِّ شيءٍ، لأنَّ اللهَ شاءَ أنْ يَحِلَّ فيهِ الملءُ كُلُّهُ وأنْ يُصالِحَ بِه كُلَّ شيءٍ في الأرض كما في السَّماواتِ، فبِدَمِهِ على الصَّليبِ حُقِّقَ السَّلامُ. (كولوسي 1: 17–20)
الله منبع المحبة الحقيقية ومبتغاها
إنّ الزواج ليس أسمى هدف للحياة، وإنما محبة الله هي الأسمى لكل من العزاب والمتزوجين. فعندما يكون صدرنا متأجّجا بمحبة الله ووصاياه أولا ثم تأتي من بعدها محبة الإخوة والأخوات في الكنيسة فسوف نعكس عندئذ صورة الله انعكاسا أكثر بهاء ولمعانا وكمالا. أما في الزواج المسيحي الحقيقي، فيعمل الزوج على توجيه زوجته وأولاده إلى الله وليس إلى نفسه. وبالطريقة نفسها ستدعم الزوجة زوجها كمُعينة له، وكلاهما سوف يعلمان أولادهما أثناء التربية على توقيرهما هما الاثنان كوالدين، ويقودانهم معا إلى محبة الله باعتباره خالقهم.
وهناك نقطة مهمة، فعندما يكون الشريك معينا لشريكه الآخر نيابة عن الله، فهذا العمل ليس مجرد التزام بل أيضا نعمة. فكم سوف تختلف وتتحسّن علاقاتنا لو أعدنا اكتشاف هذه النقطة! إذ نعيش في زمن يسيطر عليه الخوف وعدم الثقة أينما ذهبنا. فأين هي المحبة التي تبني الحياة المشتركة والكنيسة؟
هناك نوعان من المحبة: الأول، محبة مِعطاءة تتسم بنكران الذات وتتجه بشكل غير أناني نحو الآخرين ونحو خيرهم، والثاني، محبة تملكيّة ومقتصرة على محبة الذات. ويقول القديس أوغسطينوس Augustine عن المحبة المِعطاءة بتعبير مجازي (وهو من أحد آباء الكنيسة الأولى البارزين 354 – 430 م): «المحبة هي كيان روح الإنسان، وهي يدّ روحه أيضا، فعندما تمسك المحبة شيئا معيّنا فلا يمكنها أن تمسك شيئا آخرا، أما لو أُعطي لها شيئا آخرا لتمسكه، فعليها أولا أن تضع جانبا ما تمسكه ليتسنى لها مسك الشيء الآخر.»4 إن محبة الله لا تبتغي شيئا لنفسها، فهي تعطي ذاتها وتضحّي وتبذل نفسها لأن في ذلك سرورها. والمحبة تتأصّل دائما في الله.
وَنَحْنُ نُحِبُّ، لأَنَّ اللهَ أَحَبَّنَا أَوَّلاً. (1 يوحنا 4: 19)
فعسى الله أن ينعم علينا بأن تملك علينا من جديد قوة محبته لتسيير حياتنا حسبما تشاء. فسوف تقودنا إلى الآخرين لنشاركهم حياتنا في السراء والضراء. بل وأكثر من ذلك، فسوف تقودنا إلى ملكوت الله. فالمحبة سِرّ ملكوت الله الآتي.
هذا المقال مقتطف من كتاب «دعوة إلى حياة العفة والنقاوة»

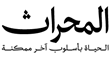





toufik 04
موضوع جيد شكرا