Subtotal: $
Checkout
لا يمكن التوفيق بين الرأسمالية وتعاليم يسوع الناصري – أو هكذا يزعم ديفيد بنتلي هارت مترجم العهد الجديد (أي الإنجيل). فإنّ السيد المسيح لم يدِن الجشع في الثروات فحسب، بل أدان أيضا ظاهرة التملُّك في حدّ ذاتها، وكان أتباع يسوع المسيح الأوائل شيوعيين متطوعين من تلقاء ذاتهم – لو جاز التعبير. وفي ظِلِّ هيمنة قوى السوق التكنولوجي على عالمنا، فهل لا يزال الاقتصاد المسيحي الحقيقي ممكنًا؟ وما مستقبل الرأسمالية، إنْ كان هناك شيء يذكر؟
1: ما الرأسمالية؟
إنّ التجارة، في جوهرها، شيطانية. فالتجارة سداد ما تم إقراضه، وإنها القرض الذي تم الحصول عليه بهذا الشرط: ادفع لي أكثر مما أعطيك.
— الشاعر الفرنسي شارلو بودلير Charles Baudelaire، من قصيدة: Mon cœur mis à nu
ليس لدي إجابة مُرضية تماما على الأسئلة التي تثير هذه التأمُّلات الفكرية المطروحة في هذه المقالة؛ ولكني أعتقد أن النهج الصحيح للإجابات يمكن رؤيته بوضوح إلى حد ما إذا أخذنا وقتا كافيا لتحديد مصطلحاتنا. فقبل كل شيء، لقد أصبحت كلمة رأسمالية في هذه الأيام، وخاصة في أمريكا، كلمة كبيرة جدا بشكل يبعث على السخرية وتُستعمل على نطاق واسع لكل أشكال التبادل الاقتصادي التي يمكن تخيّلها، مهما كان بدائيّا أو مُتخلِّفا. ومع ذلك، فأنا أعتبر أننا هنا نستخدمه بشكل أكثر دقة إلى حد ما، للإشارة إلى فترة في تاريخ اقتصاديات السوق التي بدأت بشكل جدي منذ بضعة قرون فقط. والرأسمالية، كما يعرّفها العديد من المؤرخين، هي مجموعة من الاتفاقيات المالية التي ظهرت في عصر التصنيع (الثورة الصناعية) التي حلت تدريجيا محل التجارة في العصر السابق. وكما حددها السياسي والفيلسوف الفرنسي برودون Proudhon في عام 1861م، بأنها نظام له قاعدة عامة وهي أن أولئك الذين يجنون أرباحا بمصالح أعمالهم، لا يمتلكون وسائل الإنتاج ولا يتمتعون بثمار أتعابهم.

لوحة بريشة ديبورا بات Deborah Batt، بعنوان: الاضمحلال الريفي
لقد دمَّر هذا الشكل من التجارة وإلى حد كبير القوة التعاقدية للعمالة الماهرة الحرة، واستأصل النقابات الحرفية، وقدم بدلاً من ذلك نظام الأجور الجماعية الذي قلل من شأن العمالة لينزل بها إلى مستوى سلعة قابلة لمناقشة تخفيض أجورها. وبهذه الطريقة، خلقت سوقًا لاستغلال العمال الرخيصين والمحتاجين. كما تم تشجيعها بشكل متزايد من خلال سياسات الحكومة التي قللت من خيارات المحرومين لتنزل بهم إلى مستوى رواتب العبيد أو الاعتماد الكلي على المساعدات الاجتماعية (مثلما حصل في بريطانيا عندما بدؤوا في منتصف القرن الميلادي الثامن عشر بتسييج أو تطويق نظام الحقول المفتوحة، لتصبح استخدامات الأرض مقتصرة على المالك، ولم تعد أرضًا مشتركة بين جميع الرعاة كما كان في السابق). وعلاوة على ذلك، سبب كل هذا على وجه أكيد تحولاً في السيادة الاقتصادية من فئة التجار – الذين كانوا يشترون سلعا ومنتجات بعقود من الأعمال المستقلة أو شركات فرعية أو أسواق محلية صغيرة ومن ثم يبيعونها إلى جهات أخرى – إلى مستثمرين رأسماليين أخذوا ينتجون ويبيعون سلعهم بنفسهم. وتطور هذا الأمر مع مرور الوقت وأدّى إلى خلق نظام مؤسسي لشركات ضخمة التي حوّلت الشركات المساهمة للتجارة المعاصرة إلى محركات لتوليد رأس مال هائل على المستوى الثانوي من المضاربات المالية: أي بمعنى سوق مالي بحت حيث يتم تكوين الثروات لأجل أولئك الذين لا يتعبون ولا يكدحون ولكي يتمتعون بهذه الثروات، ولكنهم بدلاً من ذلك ضليعون في عملية مستمرة من تدوير الاستثمارات وسحب الاستثمارات، كنوع من ألعاب الحظ.
لهذا السبب، قد يقال إنّ الرأسمالية قد حققت التعبير الأمثل لها في نهوض الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة، وهي مؤسسة تسمح بلعب اللعبة بطريقة تجريدية حتى لو كانت الشركات المستثمرة قد نجحت في النهاية أم فشلت. (فيمكن للمرء أن يستفيد من تدمير سبل العيش بقدر ما يستفيد من إنشائها). فإنّ مثل هذه الشركات هي كيان ماكِر حقًا: لأنها تتمتع حسب القانون باعتراف شرعي كونها تُعتبر في نظر القانون شخص اعتباري – وهو امتياز قانوني كان لا يُمنح سابقًا إلّا «للجمعيات التعاونية» المعترف بها على أنها تقدم منافع عامة، مثل الجامعات أو الأديرة – أما الآن، فإنّ هذه الشركات صار مطلوب منها بموجب القانون أن تتصرف كأحقر شخص يمكن تخيله. ففي كل مكان تقريبًا في العالم الرأسمالي (في أمريكا، على سبيل المثال، منذ اتخاذ قرار عام 1919م في قضية Dodge v. Ford)، فإنّ مثل هذا النوع من الشركات لا ترمي إلى أيّ هدف إلّا إلى أقصى مكاسب لمساهميها؛ ويحظر عليها السماح لأي اعتبار آخر يعيقها عن سعيها هذا – أي بمعنى اعتبارات صالحة مثل حساب ما يشكل أرباحًا لائقة أو غير لائقة، أو مصلحة العمال، أو قضايا خيرية قد تؤدي إلى تحويل الأرباح، أو مقدار ممتلكاتك.
لذلك، فإنّ أخلاق مثل هذه الشركات مرهون بانعدام البعد الأخلاقي. ومن الواضح أن نظامها كله هذا لا يكتفي بأن يضع في حسبانه التركيز الهائل على رأس المال الخاص واتخاذ القرارات المناسبة بكامل التصرُّف بشأن تسخير رأس المال هذا دون قيود على قدر الإمكان، بل يعتمد أيضا على هذين العنصرين بشكل إيجابي. ويسمح نظام هذه الشركات باستغلال الموارد المادية والبشرية على نطاق هائل بشكل لم يسبق له مثيل. وسيؤدي هذا حتما إلى خلق ثقافة النزعة الاستهلاكية، لأنه يجب أن يزرع عادة اجتماعية للاستهلاك التجاري بشكل مبالغ فيه يتجاوز مجرد الحاجة الطبيعية أو حتى (ربما يمكن القول) يتجاوز الابتغاء الطبيعي. ولا يكتفي الأمر بإشباع الرغبات الطبيعية؛ إذ تُحتِّم الثقافة الرأسمالية على نفسها أن تسعى دون توقف إلى اختلاق رغبات جديدة، من خلال استمالة واجتذاب ما يسميه الإنجيل في رسالة يوحنا الأولى: «شَهْوَةَ الْعُيُونِ.»

لوحة بريشة ديبورا بات Deborah Batt، بعنوان: القرية الحضرية
إنّ أقل ما يمكن للمرء الاعتراف به هو أن الرأسمالية «تنجح في عملها.» أي أنها تنتج ثروة هائلة، وتتكيف بمرونة عجيبة حتى مع أكبر التغيرات المفاجئة في الظروف المادية والثقافة المجتمعية. وعندما كانت تتعثر، هنا أو هناك، قامت بتطوير آليات جديدة لمنع ارتكاب الخطأ نفسه مرة أخرى. وبطبيعة الحال، إنها لا تؤدي إلى توزيع عادل للثروات؛ ولا يمكنها ذلك. وليس لدى المجتمع الرأسمالي أيّ مشكلة مع تواجد طبقة فقيرة بل إنه يتطلب وجودها قطعيّا، ليس من أجل قيمتهم كأيدي عاملة احتياطية فحسب، بل أيضا لأن الرأسمالية تعتمد على نظام اقتصادي ائتماني مستقر ومرتكز على تقديم الديون والقروض والدفع بعد الاستلام مقابل فوائد، وإنّ الاقتصاد الائتماني يتطلب قدرًا معينًا من المدينين الدائميين الذين يمكن تحويل فقرهم – من خلال ممارسات الإقراض المفترس ورسوم الفوائد – إلى رأس مال للدائنين.footnote أما العجز الدائم عن دفع الديون للطبقة العاملة الفقيرة وللطبقة الوسطى من ذوي الدخل المتوسط، فيمثل ينبوع أرباح لا ينضب للمؤسسات التي تعتمد عليها الطبقة الاستثمارية.
يمكن للمرء أن يقرّ أيضا بأن العوائد المالية الهائلة التي يحصدها القِلّة، بين الحين والآخر، يمكن أن تكون لصالح الكثيرين؛ ولكن لا توجد قاعدة ثابتة لهذه الفائدة، وعموما غالبا ما يكون العكس هو الصحيح. إذ يمكن للرأسمالية أن تصنع إيجابيات وتثري أو تُدَمِّر وتُفَقِّر، كما تقتضي مصلحتها؛ ويمكنها تشجيع التحرر والإنصاف أو التحريض على الطغيان والظلم وعدم المساواة والطبقية، كما تملي عليها الضرورة. وليس للرأسمالية صلة طبيعية بمؤسسات الحريات الديمقراطية أو الليبرالية. وليس لها طبيعة أخلاقية على الإطلاق. فإنها عبارة عن نظام لا يمكن لأحد أن يعبث به أو يسيء استخدامه، بل مجرد له القابلية على التقليل أو زيادة فعاليته. ولكن، بطبيعة الحال، عندما يُنظر إلى الرأسمالية بأيّ منظار أخلاقي أبعد من التمييز بين الخير والشر، فنرى أن الرأسمالية في جوهرها هي شَرّ.
فلكل هذه الأسباب، يبدو من الحكمة في نظري أننا اخترنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: ما الشيء الأسمى من الرأسمالية؟ وليس هذا السؤال: ماذا سيأتي بعد الرأسمالية؟ فبقدر ما أستطيع أن أرى، فإنّ ما سيأتي بعد الرأسمالية – أي ما سيُثمِر منها في المسار الطبيعي للأشياء – هو لا شيء ذو شأن. وهذا ليس لأني أعتقد بأن انتصار أوضاع سوق الشركات البورجوازية يشكِّل «نهاية التاريخ،» أي بمعنى النتيجة المنطقية النهائية لبعض المادية الجدلية المُتعذِّر تغييرها. حتى إني لا أتخيل أن منطق الرأسمالية قد فاز بالمستقبل، ولا أؤمن بأن حكمها سيدوم إلى الأبد. وفي الواقع، أظن أنها نظام لا يدوم على المدى الطويل.
وأستند في قناعاتي هذه بالأحرى على حساب بسيط للغاية وهو عدم التناسب بين الجشع اللانهائي والموارد المحدودة. فإنّ الرأسمالية بطبيعتها هي اختلال شديد في القوى العقليّة ينتشر بشكل وحشي، وهو في النهاية، إذا ما تُرِك ليقرر بنفسه، فسيحوّل كل النظام الطبيعي إلى صحراء: مسلوبة، وخربانة، ومُسمَّمة، ومُدنَّسة. وإنّ الكوكب بأسره غارق سلفا في جو من جزيئات اللدائن البلاستيكية الدقيقة، ومُغلَّف بكفن سميك من الانبعاثات الكربونية، ومغمور بسيل فائض من المعادن الثقيلة والسموم. وليس لديّ أيّ توقُّع لحصول أيّ دافع معاكس سيعرقل تقدم الرأسمالية نحو هذه النهاية التي لا مفر منها، دوافع صالحة مثل: غريزة البقاء على قيد الحياة، أو عواقبية أخلاقية مُتعقِّلة،footnote أو حماسة لرعاية الطبيعة، أو توقير تلقائي لبهاء الخليقة.
إنّ الرأسمالية في الأساس هي عملية تأمين فوائد ماديّة مؤقتة من خلال التدمير الدائم لأساسها المادي. فإنها نظام الاستهلاك الكلي، ليس فقط بالمعنى التجاري، ولكن أيضًا بمعنى أن منطقه الضروري هو أنقى صيغ مذهب العدميّة، التي معناها رفض جميع المبادئ الدينية والأخلاقية، والاعتقاد بأن الحياة لا معنى لها، وهو التزام بتحويل وفرة المواد الموجودة والملموسة إلى قيمة لا ماديّة صرفة. لذلك، أتوقع أن الرأسمالية لن تستنفد طاقاتها الذاتية التي تتميز بها لغاية أن تستنزف العالم نفسه، باستثناء مظهر بعض الوكالات العرضية والمضادة للتيار الرأسمالي. وسيكون هذا في الواقع علامة على انتصار الرأسمالية النهائي وهو: التسليم الكلي لآخر بقايا القوى المؤمنة بالخير المطلق التي تقاوم الباطل إلى أيادي السرمدية الفيثاغورية غير المحسوسة للقيمة التجارية السوقية. وإنّ أيّ قوة قادرة على إيقاف هذه العملية الكارثية، لابد أن تأتي من خارج نطاق الرأسمالية.

لوحة بريشة ديبورا بات Deborah Batt، بعنوان: مجتمع
2: خارج نطاق الرأسمالية
نحن نعلم أن اليهود مُنِعوا من التحقيق في المستقبل… ولكن هذا لا يعني أن المستقبل بالنسبة لليهود تحوّل إلى وقت متجانس وفارغ. إذ كانوا يترقبون البوابة الضيقة في كل ثانية من الوقت لَعَلَّهم يرون المسيح يدخلها.
– قول مقتطف من مقالة بقلم والتر بنيامين Walter Benjamin، بعنوان: Theses on the Concept of History (أي بمعنى: أطروحات حول مفهوم التاريخ).
بصراحة، ليس من الصعب للمرء أن يتخيّل الغاية النهائية لماهية الـ «خارج نطاق.» فإنها الشيء نفسه تقريبا الذي تتوق إليه جميع التوجهات الرشيدة المُتعقِّلة بشتى أنواعها، والمشابهة تقريبا للعالم الروحاني السامي، مثل: سنة اليوبيل، أو لاسلطوية هنيئة،footnote أو شيوعية خالصة، أو واقعية إنسانية ودنيوية حيث لا يمكن للجشع أن يجد شيئا يتشبث به لأنه لا أحد يملك شيئا، ولا يوجد أيضا أيّ شيء مُفْرِح أو مفيد غير متاحٍ للجميع، وتجري مقاسمة كل الأشياء في مجتمع قوامه المحبة الرشيدة. حتى أن المؤمن بسذاجة النيوليبرالية الهاذية،footnote الذي يؤمن باقتصاد الموارد الجانبية هو في الحقيقة شيوعي لاسلطوي بأقصى نواياه المعنوية، حتى لو لم يعلم هو بنفسه بذلك؛ إذ ينام في مكان ما في أعماق كيانه شخصية بيتر كروبوتكين،footnote ويحلم بعالم مُنَظَّف من الجشع والعنف. ففي قلب كل إنسان، يكمن اشتياق إلى الفردوس الأرضي، إلى جنة عدن كنهاية القصة بدلاً من بدايتها غير القابلة للاسترداد.

أخبرني، هل تبحث حقاً عن ثروات ومكاسب مالية من المعوزين؟ فإذا كان لدى هذا الشخص المعوز الموارد التي تجعلك أكثر ثراءً، فلماذا جاء يشحذ عند بابك؟ لقد جاء باحثا عن حليف ولكنه وجد عدوًا. وجاء باحثا عن دواء، فإذا به يجد سَمّاً. ورغم أنك ملزم بمعالجة وبلسمة فقر مثل هذا الشخص، إلّا أنك بدلاً من ذلك تزيد من حاجته، وتسعى للحصول على حصاد من الصحراء القاحلة.
القديس باسيليوس الكبير Basil the Great، من كتابه الدفاعي: Against Those Who Lend at Interest
إلّا أن جنة عدن هي ليست القضية الجدلية للتاريخ، أي بمعنى هي ليست الثمرة النهائية لعقلانية خفيّة وغامضة وسرّيّة تنجح من تلقاء نفسها في حلّ التناقضات الظاهرة للأمور المحدودة. فإنها أسمى من ذلك بكل ما تعنيه الكلمة. فهي لا تشغل زمنا معينا إلّا لكونها دينونة تدين زماننا الحاضر ولا تأتي إلّا في الآخرة، وهي بمثابة تذكير مستمر لنا بالنظام الصالح للخليقة الذي نغدر به باستمرار. ونحن نعلم بأن الجنة هي بالدرجة الأولى إدانة للخطايا، وهي ليست دائما رجاء إلّا بالدرجة الثانية. أما كيفية ترجمة تلك الدينونة كقوة ملازمة للتاريخ والقوة الوحيدة القادرة على تهشيم سيادة رأس المال قبل أن يبقى أي شيء منه لإنقاذه، فهي السؤال الكبير لكل الفكر السياسي لأي مادة حقيقية في العالم الحديث.
وعلاوة على ذلك، إنها مسألة لا يمكن للمسيحيين تحاشيها. والحقّ يقال إنّ التاريخ الاجتماعي والمؤسساتي للكنيسة يعطي شيئا من الأمل في أن الكثير من المسيحيين كانوا على دراية تامة بهذه المسألة. ولكنهم سواء كانوا يهتمون بالاعتراف بما يتضمنه إيمانهم المسيحي بشكل كامل أو لا، فإنّ المسيحيين لا يزالون مُلزمين بأن يؤكِّدوا على أن هذه الدينونة الأخيرة قد ظهرت بالفعل في التاريخ، وبصورة مادية واجتماعية وسياسية معينة. ويجعلك إنجيل يوحنا تشعر بالضيق بشكل خاص وبدرجة كبيرة فيما يتعلق بتدخُّل القضاء الإلهي الوشيك، الذي لا مفر منه، على كل بنية أثيمة تنتمي إلى نظام العالم الدنيوي. فهناك تكاد تكون الدينونة حاضرة تماما. إذ يمرّ المسيح هناك عبر التاريخ، كالنور الذي يكشف حقيقة كل الأمور حسب ما هي عليه؛ أما الذي سيرينا حقيقة أنفسنا فهو متوقف على مدى استجابتنا له – أي بمعنى قدرتنا أو عدم قدرتنا على إدراك ذلك النور. فإنّ رؤيته معناها رؤية الله الآب. وعليه، فإنّ رفض المرء لله معناه إعلان الشيطان كآب بديل عنه. فقلوبنا مكشوفة، وأصبحت أعمق القرارات التي اتخذناها في كياننا السري مكشوفة، وأصبحنا مكشوفين كما نحن عليه – وعلى حقيقة ما جعلنا أنفسنا على شاكلته.
في الحقيقة، إنّ ما يخبرنا بذات الشيء هو ليس إنجيل يوحنا فقط. إذ تخبرنا أيضًا بذات الشيء الصورة العظيمة الرمزية عن يوم الدينونة للبشير متى، إصحاح 25، على سبيل المثال. وفي إنجيل يوحنا، فإنّ إخفاق المرء في الاعتراف بالمسيح كونه الوجه الحقيقي للآب، الآتي من الأعالي، هو بحد ذاته إدانة للشخص، هنا والآن. أما في إنجيل متى، فإنّ إخفاق المرء في التعرُّف على وجه المسيح – وبالتالي وجه الله – لدى المذلولين والمضطهدين، والمتألمين والمحرومين من حقوقهم الإنسانية، إنما هو كشف لحقيقة أن الشخص قد اختار الجحيم كموطن له. فسوف يجري اختبار جميع أعمالنا وأفعالنا بالنار، كما يقول بولس الرسول؛ وأولئك الذين تفشل أعمالهم في الاختبار لا يمكنهم الخلاص إلّا «كَمَا بِنَارٍ.» كما أن العهد الجديد لا يترك لنا أي مجال للشك فيما يتعلق بنوعية الممارسات السياسية والاجتماعية الوحيدة التي يمكنها اجتياز ذلك الاختبار دون أن تُحرَق بالكامل.

لوحة بريشة ديبورا بات Deborah Batt، بعنوان: المسكن 10
ومهما تكن الرأسمالية، فإنها أولاً وقبل كل شيء نظام لإنتاج أكبر قدر ممكن من الثروات الخاصة من خلال هدر أكبر قدر ممكن من خيرات الخليقة التي تنتمي إلى الميراث المشترك للبشرية. ولكن المسيح لم يدِن الانغماس غير السليم بالثروات فحسب، بل أيضا الحصول على مثل هذه الثروات والاحتفاظ بها. والمثال الأكثر وضوحًا على ذلك، الموجود في جميع الأناجيل الإزائية الثلاثة، هو قصة الشاب الغني، وبيان المسيح عن الجمل وثقب الإبرة.
وللتأكُّد من هذا الموضوع، يمكن للمرء أن يبحث في أي مكان في الأناجيل. فالمسيح يعني بوضوح ما يقوله عندما ذكر اقتباس للنبي إشعيا: فقد مسحه روح الله ليبشر الفقراء بالأخبار السّارَّة (لوقا 4: 18). أما الأخبار التي يحملها لميسوري الحال، فكانت جادّة للغاية: «وَلَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الأَغْنِيَاءُ، لأَنَّكُمْ قَدْ نِلْتُمْ عَزَاءَكُمْ. وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الشَّبَاعَى، لأَنَّكُمْ سَتَجُوعُونَ. وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الضَّاحِكُونَ الآنَ لأَنَّكُمْ سَتَحْزَنُونَ وَتَبْكُونَ.» (لوقا 6: 24–25). وكما يقول إبراهيم للغني في الجحيم: «اذْكُرْ أَنَّكَ اسْتَوْفَيْتَ خَيْرَاتِكَ فِي حَيَاتِكَ... وَالآنَ... أَنْتَ تَتَعَذَّبُ» (لوقا 16: 25). وإنّ المسيح لا يكتفي بمطالبتنا بأن نعطي مجانا لجميع الذين يطلبون مِنّا (متى 5: 42)، وأن نعطي بسخاء بحيث لا تعرف اليد اليسرى ما تتصدق به اليد اليمنى فحسب (متى 6: 3)؛ وإنما يحرّم المسيح أيضا وبكل وضوح تخزين الثروة الدنيوية – ليس مجرد تخزينها بشكل أناني جدا – غير أنه يسمح من ناحية أخرى بتكديس كنوز السماء فقط (متى 6: 19–20). ويقول المسيح لكل من يريد أن يتبعه ببيع كل ممتلكاته والتصدُّق بثمنه (لوقا 12: 33)، ويذكر صراحة قائلا: «فَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لاَ يَتْرُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ، لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذاً» (لوقا 14: 33). وكما تقول السيدة مريم العذراء القديسة، إنّ الربّ «أَشْبَعَ الْجِيَاعَ خَيْرَاتٍ وَصَرَفَ الأَغْنِيَاءَ فَارِغِينَ.» (لوقا 1: 53) وهذا جزء من الوعد الخلاصي للإنجيل. وطبعا، إنّ أكثر ما يشدّ الانتباه ما يقوله القديس يعقوب الرسول:
أيُّها الأغنياءُ، ابكُوا ونوحوا على المَصائِبِ الّتي ستَنزِلُ بِكُم. أموالُكُم فَسَدَت وثِيابُكُم أكَلَها العِثُّ. ذهَبُكُم وفِضَّتُكُم يَعلوهُما صَدَأٌ يَشهَدُ علَيكُم ويأكُلُ أجسادَكُم كالنّار ِ. تَخزُنونَ للأيّامِ الأخيرَةِ، والأُجورُ المُستَحِقَّةُ لِلعُمّالِ الّذينَ حَصَدوا حُقولَكُمُ الّتي سَلَبتُموها يَرتَفِعُ صِياحُها، وصُراخُ الحصَّادينَ وصَلَتْ إلى مَسامِعِ رَبِّ الجُنودِ. عِشتُم على الأرضِ في التَّنَعُّمِ والتَّرَفِ وأشبَعتُم قُلوبَكُم كَعِجلٍ مُسَمَّنٍ لِيومِ الذَّبحِ. حَكمتُم على البَريءِ وقتَلتُموهُ وهوَ لا يُقاوِمُكُم. (يعقوب 5: 1–6)
كان المسيحيون الأوائل ببساطة شيوعيين – لو جاز التعبير - (كما يخبرنا سفر أعمال الرسل عن الكنيسة في أورشليم، وكما تكشف رسائل بولس من حين لآخر)، ولم يكونوا كذلك كصدفة تاريخية بل كأمر حَتميّ للإيمان. وفي الواقع، عندما قمتُ بإعداد ترجمتي الأخيرة للعهد الجديد، صادفتُ صعوبة عدة مرات في عدم ترجمة كلمة كوينونيا koinonia التي تعني مشاركة (والمصطلحات ذات الصلة) إلى كلمة مثل: شيوعية. أما الشيء الذي منعني من استعمال كلمة: شيوعية، فلم يكن بسبب وجود لديّ أدنى شك فيما يتعلق بملاءمة هذه الكلمة «الشيوعية،» ولكن الشيء الذي منعني كان أولا لأنني لم أرغب في ربط ممارسات المسيحيين الأوائل بطريق الخطأ بـ «شيوعيّ» الدولة المركزية للقرن العشرين، وثانيا لأن كلمة الشيوعية ليست وافية لتمثيل جميع الأبعاد – الأخلاقية والروحية والمادية – للمصطلح اليوناني كوينونيا كما استخدمه مسيحيو القرن الميلادي الأول بحسب الأدلة القاطعة. فلم يكن لديهم أدنى شك في أن القضية المركزية للإنجيل الذي بشّروا به كانت الإصرار على أن الثروة الخاصة وحتى الملكية الخاصة هي أمور غريبة على الحياة في جسد المسيح، [أي في مجتمع الكنيسة].
وبقي أعظم اللاهوتيين في الكنيسة على وعي بمعنى المشاركة هذا، حتى في عهد آباء الكنيسة. وبالطبع، ظلّت التحدّيات الأصلية للكنيسة الأولى على مرّ التاريخ المسيحي باقية حيّة في بعض المجتمعات الرهبانية المعينة، وكانت تندلع في بعض الأحيان في حركات «أصولية» محلية، من أمثال: حركة الفرنسيسكان الروحيين، وحركة غير المالكين الروسية، وحركة العمال الكاثوليك، وحركة برودرهوف، وإلى آخره.
وبطبيعة الحال، فإنّ المجتمعات المسيحية الطوعية الصغيرة الملتزمة بشكلٍ ما من أشكال حياة الجماعة المسيحية هي كلها جيدة جدا. ولَعَلَّها، من دون أي شك، الطريقة الوحيدة الممكنة في زماننا الحاضر التي يمكن بها تطبيق الحياة المشتركة الحقيقية لكوينونيا الكنيسة الأولى. ولكنها يمكن أن تكون أيضًا صرفا للانتباه وتلهينا عن قضية أخرى، لاسيّما إذا عجزت عن التمييز بين عزل اعتمادها على النظام السياسي الأكبر في الوقت الحاضر من جهة وبين الاكتفاء في تحقيق كيان سياسي مسيحي مثالي من جهة أخرى. عندئذ، فإنّ أيّ نقد نبوي قد يجلبونه من حياتهم المشتركة للتأثير في مجتمعهم لكي يعيش حياة أخوية حقيقية ومشاركة تامة، سيصبح مثالا يُقتدى به وسيُثمَّن أيضا، رغم أن هذه الحياة المتشاركة ذات التكريس الكامل قد تحوّلت في نظر معظم المؤمنين إلى مجرد دعوة إلهية خاصة – وربما يشعرون بأنه لا ضير في حضور كهنوتي مقدس داخل الكنيسة الأكبر – ولكن الحياة المشتركة تبقى في نظرهم غير ممكنة إلّا لعدد قليل من الناس، وليست نموذجا للسياسة العملية.
هنا يكمن الخطر الأعظم، لأنه في نظر الناس، ينبغي عدم وضع خيار الكوينونيا الكاملة لجسد المسيح إلى جانب خيارات أخرى مقبولة قبولا متساويا. إلّا أن الكوينونيا ليس فيها روح خاصة أو انتقاء اختياريّ وفقا لما يحبِّذه المرء. فإنها دعوة لا إلى الانسحاب، بل إلى الثورة. فإنها تدخل التاريخ دخولا حقيقيا لكونها إعلانا ليوم الرب: ذلك اليوم العظيم، الذي حصل سلفا عندما جاء المسيح إلى هذه الأرض؛ ولا يمكن فصلها عن الإيمان الاستثنائي بأن يسوع المسيح هو ربٌّ فوق كل شيء، وبأن نور الملكوت قد اقتحم فعلا هذا العالم، بصيغة الحياة التي سلَّمها المسيح كميراث لأتباعه، بحيث لم يكن هذا الاقتحام كشيء يظهر على مدار تطور تاريخي طويل، ولكن كعملية اجتياح. وقد تم توريث الحكم سلفا. فقد قِيلَتْ الكلمة الأخيرة سلفا. ففي المسيح، فإنّ الدينونة قد جاءت سلفا. لذلك، فإنّ المسيحيين هم أولئك الذين لم يعودوا يتمتعون بمطلق الحرية لكي يتصوّروا أو يرغبوا في أي نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي بخلاف نظام كوينونيا الكنيسة الأولى، فليس هناك أيّ مبادئ أخلاقية مشتركة غير نظام المحبة المسيحية على غرار مذهب اللاسلطوية.

أيها الأغنياء، إلى أي مدى ستدفعون الأمور بجشعكم المحموم؟ أأنتم وحدكم الذين يسكنون على هذه الأرض؟... لقد كانت الأرض في بدايتها مشتركة للجميع، وكان المقصود منها أن تكون للأغنياء والفقراء على حد سواء؛ فبأيّ حقّ تحتكرون الأرض؟ إنّ الطبيعة لا تعرف أيّ شيء عن الأغنياء؛ فكلهم في نظرها فقراء عندما تأتي بهم. فنحن نولد بدون جميع هذه الملابس والذهب والفضة، والطعام والشراب والأغطية؛ وتستقبل الطبيعة أولادها عراة في القبر، ولا يمكن لأحد أن يأخذ فدادين أرضه معه هناك.
القديس أمبروز من ميلانو Ambrose of Milan، من كتابه: On Naboth

لوحة بريشة ديبورا بات Deborah Batt، بعنوان: تطوير إضافي
بطبيعة الحال، يجب مواصلة السعي إلى إيجاد الأهمية السياسية لهذه الحقيقة، على الأقل فيما يتعلق بالتحرُّك والعمل وبذل الجهود في وقتنا الحاضر. وكما قلتُ في البداية، ليس لديّ إجابة جاهزة لتسليمها. ولكن، كما قلت أيضًا، يمكننا على الأقل تحديد شروطنا. ويمكننا بالتأكيد تحديد الحقائق السياسية والاجتماعية التي يجب أن تكون بغيضة للضمير المسيحي، مثل: أخلاقيات ثقافية تسمح بل تشجّع حياة لا تتوقف فيها رذيلة الاكتساب والتحصيل والابتغاء كنوع من الأخلاق الحسنة؛ أو نظام قانوني خاضع لأوامر الشركات المهتمة بتحقيق أقصى قدر من الأرباح، بغض النظر عن الأساليب المستخدمة أو التبعات الناتجة عنها؛ أو سياسات الوحشية أو الانقسامات أو الهوية الوطنية أو أي من الطرق التي لا تعد ولا تحصى التي نبتكرها لترسيم الحدود القانونية لما هو «ملكنا» وليس «ملكهم».
قبل كل شيء، يجب أن نسعى إلى تحقيق رؤية للصالح العام (بأي وسيلة خيرية نقدر عليها) بحيث تفترض أن أساس القانون والعدالة لا يكون الحقّ الحصين في الملكية الخاصة، بل من المفروض أن يكون الحقيقة الأكثر أصالة التي يعلّمها ناس من أمثال القديس باسيليوس الكبير Basil the Great، والقديس غريغوريوس النيصي Gregory of Nyssa، والقديس أمبروز من ميلانو Ambrose of Milan، والقديس يوحنّا الذهبي الفم John Chrysostom، وهي أن: خيرات الخليقة مُلك للجميع بالتساوي، وأن الثروة الهائلة للقطاع الخاص هي سرقة – خبز مسروق من الجائعين، وملابس مسروقة من العريانين، ومال مسروق من المحرومين.
ولكن الكيفية التي نسعى بها إلى سياسة مسيحية حقيقية في هذه الساعة – على الأقل، على افتراض أننا نأمل بالفعل في تغيير شكل المجتمع – هي بأسرها سؤال صعب جدا، وربما لن نكون قادرين على معالجته إلّا إذا تعلمنا حقًا لأول مرة أن نحرر أنفسنا من فكرة الافتراضات المادية التي علمتنا الرأسمالية أن نؤويها على مدى أجيال عديدة.
رغم ذلك، وفي ضوء الدينونة التي دخلت التاريخ البشري في المسيح، فإنّ المسيحي لا يُسمح له بأن يشتاق ويضع آماله أساسا في مجتمع غير المجتمع الشيوعي واللاسلطوي الحقيقيين، وبطريقة متميزة جدًا التي كانت تسير بهما الكنيسة الأولى في آن واحد. وحتى الآن، وفي وقت الانتظار، فإنّ كل من لا يتصوّر حقاً مثل هذا المجتمع، ولا يرغب في أن يأتي إلى حيز الوجود، ليس لديه فكر المسيح.

ألا يُسمّى الشخص الذي يَسلب ملابس غيره لِصَّا؟ وأولئك الذين لا يكسون العراة عندما يكون لديهم القدرة على القيام بذلك، ألا ينبغي أن يطلق عليهم هذه التسمية نفسها؟ فإنّ الخبز الذي تستبقيه لنفسك هو في الحقيقة للجائعين، والملابس التي تستمر في الاحتفاظ بها هي للعريانين، والأحذية التي تتعفن دون الاستفادة منها هي للذين لا يملكونها، والفضة التي تحتفظ بها في الأرض هي للمحتاجين.
القديس باسيليوس الكبير Basil the Great، من كتابه: I Will Tear Down My Barns
هوامش
الإقراض المفترس (بالإنجليزية: Predatory lending) يعني فرض شروط تعسفية ذات ممارسات احتيالية وجائرة على المُقترض بما يعرضه لأخطار مالية جانبية مقابل الحصول على القرض.
عواقبية consequentialism عقيدة تقول إنّ أخلاق أيّ عمل أو تصرُّف يجب أن يُقيَّم من خلال عواقبه فقط.
مذهب اللاسُلطويّة Anarchism هي فلسفة سياسية تؤمن بإلغاء النظام الحكومي وتدعو إلى تنظيم مجتمعات من دون دولة مبنية على أساس جمعيات تطوعية تعاونية وغير هرمية دون اللجوء إلى القوة أو الإكراه، وذلك لأنها ترى بأن جميع أشكال السُلطة الحكومية تتسم باللاأخلاقية وغير مرغوب فيها ولا ضرورة لها البتة، وتعارض اللاسُلطويّة السُلطة في تسيير العلاقات الإنسانية. ونشطت هذه الحركة في عدد غير قليل من الدول.
النيوليبرالية Neoliberalism وهي أيديولوجية لتفضيل الأسواق الحرة وانعدام التنظيم الرأسمالي، وهي تختلف عن الليبرالية الجديدة أو الليبرالية الاجتماعية New Liberalism.
كان بيتر كروبوتكين Peter Kropotkin (ولادة 9 ديسمبر/كانون الأول 1842 - وفاة 8 فبراير/شباط 1921م) ناشطا روسيا وثوريا وعالما وجغرافيّا، الذي ناصر الشيوعية اللاسلطوية Anarcho-communism.

الكاتب ديفيد بنتلي هارت David Bentley Hart فيلسوف وكاتب ومترجم ومعلق ثقافي. ومن كتبه الأخيرة، العهد الجديد: ترجمة، وكتابه المقبل: That All Shall Be Saved: Heaven, Hell, and Universal Salvation (Yale University, 2019).
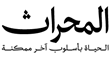




ouakil
انتم الافضل دائما